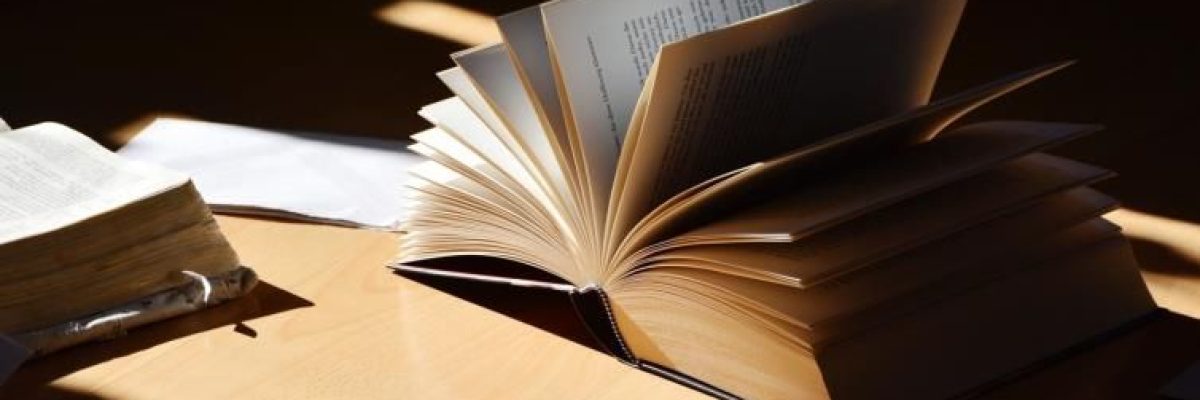اخبار اليوم الصحيفة, خمسة كتب تقدم اخبار اليوم الصحيفة, خمسة كتب تقدم
مع الانتشار المتزايد للثقافة العلمية في الوطن العربي اصبحت هناك رغبة عند الكثيرين لفهم طبيعة العلم، لا اقصد هنا المواد العلمية كالثقوب السوداء والبيولوجيا التطورية او النظرية النسبية العامة ومشكلة الكوانتم، بل العلم ذاته، كيف يعمل؟ كيف يتقدم؟ والاهم من ذلك هو: كيف نميز بين ما هو علمي وما هو غير علمي؟ ثم، لماذا ينجح العلم في تجاوز المنهجيات الاخرى بتلك الدقة والسرعة؟ وكيف يمكن ان يؤثر ذلك على مجتمعاتنا بشكل عام او خاص؟ وهل يمكن استخدام العلم كاداة سلطة في يدي رجال السياسة مثلا؟.. الخ.
يهتم بالجدل حول تلك الموضوعات فرع من الفلسفة يسمى “فلسفة العلم”، وسوف يكون هذا التقرير تقديما لمجموعة من الكتب المهمة التي يمكنها ان تساعدك في البدء مع هذا الفرع المهم من الفلسفة، ودعنا -كالعادة- نبدا بتوضيح ان كل الكتب التي سيتم الحديث عنها في هذا التقرير قد قام الكاتب بقراءتها كليا او جزئيا لتحديد مدى مناسبتها للقارئ المبتدئ، كذلك فان تلك الخطة هي التي اعتمد عليها كاتب المقال بالاساس لتعلم فلسفة العلم بشكل ذاتي، نحن اذن لا نعبّئ الكتب في دلو ونلقيه بوجهك، بل هي ترشيحات من قارئ نهم في هذا المجال الممتع.
فلسفة العلم في القرن العشرين
هذا الكتاب هو، كما اظن، افضل بداية ممكنة مع فلسفة العلم، مؤلفته هي الدكتورة يمنى طريف الخولي استاذة فلسفة العلوم بجامعة القاهرة، وكونها قد مارست التدريس لفترة طويلة وتعرّفت على اولويات الطلبة اعطاها قدرة واسعة على سرد المادة الفلسفية بطريقة تتراقص ما بين الشرح الاكاديمي والتبسيط غير المخل، ما يجعل الكتاب واحدا من اهم كتب فلسفة العلوم الصادرة باللغة العربية، والوحيد في هذه القائمة الذي كتبه مؤلف عربي، والكتاب للعلم معروض بشكل مجاني على موقع مؤسسة هنداوي يمكن لك ببساطة تحميله من هناك.
تبدا د. يمنى بمقدمة مهمة “ظاهرة العلم هي اخطر ظواهر الحضارة الانسانية، واكثرها تمثيلا لحضور الانسان، الموجود العاقل، في هذا الكون”، ثم تنطلق بعد توضيح اهمية هذا النطاق المعرفي بوضع مدخل مهم للعلاقة بين فلسفة وتاريخ العلم، وهو -ربما- الموضوع مركز الجدل الرئيس في فلسفة العلم، حيث يجيب عن اسئلة مهمة مثل: متى بدا العلم تحديدا؟ ولماذا توجد علاقة متوترة بين العلم وتاريخه؟ والنقلة بين العلم الحديث والعلم القديم.
بعد ذلك تنتقل يمنى الخولي الى اساسات فلسفة العلم في القرن العشرين، لتبدا -خلال الجزء الرئيس من الكتاب- بالحديث عن المدرسة الوضعية المنطقية، اصولها وتطورها، ثم تنتقل في الفصلين الاخيرين الى الحديث عن سقوط الوضعية المنطقية بظهور فلسفة كارل بوبر، ثم توماس كون، ثم مقدمات لفلسفة باول فييرابند وعلم اجتماع العلماء والتيارات النسبوية والنسوية، والمهم هنا انها تخصص جزءا رئيسا من الكتاب لشرح ثورة الفيزياء الكبرى واثرها على فلسفة العلم بدايات القرن العشرين.
للوهلة الاولى يبدو اسلوب يمنى الخولي صعبا على مبتدئ، لكن الامر يتطلب فقط بعض التمرن والتمرس على اسلوبها في الكتابة وسوف تطور قدرات اكبر على الاستمرار معها فيما بعد، يمكن لك كاضافة ان تستعين بمحاضراتها في فلسفة العلم والمنشورة على قناة اليوتيوب الخاصة بالتعليم المفتوح، جامعة القاهرة، كاضافة لتسهيل الخوض في الكتاب، لكن في النهاية فان نطاق فلسفة العلم ليس بسهولة القراءة المبسطة، سوف تحتاج من حين لاخر ان تخرج من الكتاب للتعرف على بعض الاصطلاحات ربما عبر يوتيوب او من جوجل.
يمنى الخولي كذلك هي من ادخل كارل بوبر الى ارض اللغة العربية، فقد كانت رسالة الدكتوراه الخاصة بها عن كارل بوبر، ولذلك فان لها عدة كتب تصلح للقارئ المتقدم في هذا النطاق، كـ “فلسفة كارل بوبر” و”العلم والاغتراب والحرّية”، و”فلسفة العلم من الحتمية الى اللاحتمية”، اما عن كتاب “مفهوم المنهج العلمي” الصادر حديثا لها فهو مصدر مختصر مهم للعديد من الموضوعات المهمة الخاصة بما يعنيه المنهج العلمي وكيف تتطور ووجهات النظر الناقدة له.
فلسفة العلم.. اربعة موضوعات رئيسية
في المرحلة الثانية من قراءاتك لا بد وان تلقي نظرة على كتاب دونالد جيليز الشهير “فلسفة العلم في القرن العشرين: اربعة موضوعات رئيسية”، الكتاب اكثر صعوبة من سابقه، لكن المهم هنا هو انه يلقي نظرة مختلفة على تاريخ وفلسفة العلم لن تجدها في كتاب يمنى الخولي السابق، حيث يبدا جيليز، استاذ الفلسفة بكلية كينجز، لندن ستراد، بمشكلة الاستقراء، ثم ينتقل الى منهج كارل بوبر ونزعته التكذيبية ورفضه للاستقراء، في الفصل الثالث يبدا جيليز في شرح الاصطلاحية ومشكلة دوهيم-كواين وهو امر لم تتطرق اليه يمنى الخولي بوضوح، بينما يهتم جيليز كثيرا بتوضيحه للقارئ.
في الحقيقة تعتبر اطروحة “دوهيم-كواين” نقلة مركزية في تطور فهمك للفلسفة بعد كارل بوبر، سواء كانت تلك النقلة هي زلزال توماس كون او ما تلاه من الحركات ما بعد الحداثية، النسوية، وعلم اجتماع العلماء.. الخ، ويمكن القول ان جيليز يشرح تلك المنطقة بمهارة وتبسيط رائعين، خاصة انه يتقدم ليتحدث عن الملاحظة المحملة بالنظرية، ثم اخيرا، في الموضوع الرابع يتحدث جيليز بشكل منفصل عن ترسيم الحدود بين العلم والميتافيزيقا، ليبدا بسؤال اول مهم وهو: هل الميتافيزيقا لا معنى لها؟ فيشرح وجهة نظر فيتجنشتين، ثم حلقة فيينا، ونقد كارل بوبر لها.
اسلوب جيليز لا شك سهل، يساعدنا في فهمه قدرة المترجم على فهم دقائق فلسفة العلم وترجمتها بشكل دقيق وانيق في نفس الوقت، يضرب جيليز الامثلة بشكل دائم ويقدم كتابا للقارئ غير المتخصص وهو ما اعلنه في مقدمة الكتاب، لكن رغم ذلك ارى ان هذا الكتاب يصلح تاليا لكتاب يمنى الخولي بالاعلى ومكملا له، وكلاهما، معا، يمثلان مقدمة قوية يمكن للمتمكن منها ان يمضي في فلسفة العلم بخطى ثابتة لمراحل متقدمة.
فلسفة العلم – مقدمة معاصرة
هذا كتاب جيد عن فلسفة العلم، للفيلسوف الاميركي اليكس روزنبرج من جامعة ديوك، لكن يعيبه شيء واحد فقط وهو الترجمة السيئة، بل ان المترجم قد اخطا، ليس فقط في ترجمة تعابير لغوية بعينها، بل ايضا في اصطلاحات كـ (Double blind Study) والتي تعني دراسة مزدوجة التعمية لا يعرف الخاضعون لها والقائمون عليها بماهيتها ليترجمها بـ “مرض العمى المزدوج”! على الرغم من ذلك يمكن لك بسهولة الحصول على نسخة انجليزية عبر الانترنت بسهولة، او يمكن ان تحاول تفادي الخطا بالنسخة العربية، حيث تنبع اهمية الكتاب من عدة نقاط مهمة، اولها انه يتناول نفس الموضوعات لكن من وجهات نظر معاصرة، اي انه لا يضرب امثلة تاريخية بقدر ما يضرب امثلة معاصرة عن -مثلا- مشكلات الناس مع التاخر في اصدار ادوية جديدة او ارتباط السببية بموضوعات حديثة في الفيزياء الذرية.. الخ.
اضف الى ذلك ان هناك اربعة اجزاء مهمة يوردها روزنبرج في كل فصل، الاول هو نظرة عامة على الفصل، ثم ملخص للفصل، ثم اسئلة لتجيب عنها، ثم مقترحات للقراءة، تعمل الاسئلة على اختبار مدى فهمك للمادة التي قُدمت لك، وهي بذلك تخبرك عن مدى تقدمك في التعلم، لكن ما يهم حقا هنا هو مقترحات القراءة، لان ذلك هو باب غاية في الاهمية لا نجده كثيرا في الكتب، حيث يمكن لك فيما بعد ان تجد عبر تلك المقترحات ما يمكن ان يكون خطّة اساسية متقدمة للتعمق في فلسفة العلم بصورة افضل وعبر مقترحات من متخصصيها، وروزنبرج لا يضع لك قوائم فقط، بل يشرح في سطر او اثنين او اكثر فائدة المقترح واهميته ضمن نطاق محدد من القراءة، هذا الجزء من كل فصل هو كنز حقيقي.
الكتاب اذن، كما ترى، مقدم في صورة منهج للدراسة، ويقول كاتبه -والكتاب يقترب من قوله قليلا- انه مصمم لطلبة الفلسفة ولغيرهم كذلك، كذلك فان احد اهم مميزات الكتاب هو عرضه لموضوعات مختلفة قليلا عن تلك الموجودة في سابقَيه، فمثلا يبدا بتعريف اصطلاح فلسفة العلم في الفصل الاول، ويبدا بطرح التعقيدات المتعلقة بفكرة التعريف ومدى مناسبتها للسياق العلمي والفلسفي، خاصة حينما نتفحص الاختلاف الجوهري بين اسئلة يطرحها العلم واخرى تطرحها الفلسفة.
بعد ذلك ينتقل روزنبرج الى فصل خاص عن السببية وما نسميه بالنموذج المونولجي للتفسير، والذي قدمه الوضعيون المناطقة، ويقدم من خلاله الضرورات الاساسية لعملية التفسير العلمي كالصدق وقابلية الاختبار والالزام المنطقي… الخ، ثم ينتقل الى تقييم تلك التفسيرات ايها جيد وايها ليس كذلك، ثم ينتقل -مثل جيليز- الى الحديث عن الميتافيزيقا والعلم، واخيرا الى ابستمولوجيا التنظير العلمي، نظرية المعرفة يقصد، ويشرح تطور المنهج من الاستقراء حتّى دوهيم كواين، وعلاقة ذلك بالطبيعة الاحصائية لبعض العلوم، واخيرا ينتهي بعصر ما بعد الوضعية، ليسال عن مدى عقلانية العلم.
الكتاب في المجمل سهل، ويمثل دعما جيدا لسابقيه، واسلوب روزنبرج يتميز بانه معاصر، ويخاطبك بصلابة لكنه يشرح اصطلاحاته، والمنهجية المدرسية في الكتاب تعطيك درجة من الراحة وتعطيك شعورا محببا الى القلب بانك في فصل دراسي وان هناك من يشرح دروس الفلسفة لك، كل ما تحتاجه هو التركيز ومحاولة تقصّي ما يحاول روزنبرج ان ينقله لك.
مقدمة في فلسفة العلم – النظرية والواقع
كان هذا الكتاب ليوضع في مقدمة تلك القائمة بسهولة وبمسافة بالغة الاتساع عن اقرب منافسيه، لولا انه الكتاب الوحيد غير المترجم فيها، انه كتاب “مقدمة في فلسفة العلم – النظرية والواقع” (an Introduction To Philosophy Of Science – Theory and Reality) للفيلسوف بيتر جودفري-سميث (PETER GODFREY-SMITH)، وهو استاذ الفلسفة بجامعة نيويورك، وهذا الكتاب هو نتاج مجموعة من المحاضرات في فلسفة العلم والتي القاها في جامعة ستانفورد، هنا ننطلق لفهم سر تميز كتاب جودفري-سميث، وهو انه مقدم في صورة منهج للطلبة.
رغم ذلك فان جودفري-سميث يقول في مقدمته ان الكتاب يصلح للطلبة ولغيرهم من المبتدئين، وقد صدق في قوله قدر ما اظن، فقد كان الكتاب اساسيا في رحلتي الخاصة لتعلم فلسفة العلم، حيث يقدم كاتبنا لفلسفة العلم، لا في شكل موضوعات مقاليه الهيئة والمحتوى، بل في ملاحظات مشروحة جيدا ومفصلة ببساطة للطالب الذي يود استذكار منهج ما، وهذا هو كما اظن احد افضل واهم طرق التعلم، ان نترك الجدل جانبا كبداية لنتعلم الاساسيات.
لذلك، فرغم ان كتاب سميث في حوالي 250 صفحة فقط فانه يشتمل على معظم الموضوعات الاساسية في فلسفة العلم، بداية من مقدمة مختصرة عن تاريخ العلم، ثم فلسفة العلم قبل الوضعية المنطقية، ثم الوضعية المنطقية، فـ كارل بوبر، ثم يتعمق قليلا وبحرفية وبساطة في توماس كون، الى ان يصل الى فييرابند فيشرحه جيدا، وكذلك فهو يشرح امري لاكاتوش، ولاري لودان، ثم لا يقف هنا، وهي نقطة مهمة جدا.
حيث يستمر جودفري-سميث بالاشارة الى سوسيولوجيا المعرفة العلمية، نشاتها وعلاقتها بتوماس كون، ويعطي مقدمة جيدة جدا لها، بعد ذلك ينتقل الى نطاقين لا يشرحهما اي من المصادر السابقة، وهما الفلسفة الطبيعانية، والمدرسة الواقعية، في فلسفة العلم، ثم ينتقل الى النسوية في العلم، والطبيعة الاحصائية للمعرفة العلمية، وفي كل مرة يربط سميث بين كل فصل وسابقيه ليظهر لك الكتاب في النهاية كشجرة من المعارف يمكن بسهولة ان تعرف اين تبدا فيها واين تنتهي.
كتاب جودفري-سميث هو كتاب للاستذكار يحمل منهج فلسفة علم لطلبة السنة الاولى الجامعية او الثانية، وهذه هي اهم مزاياه، وهو مثل روزنبرج يضع في نهاية كل فصل كتبا اخرى للتوسّع، لكن بالطبع سوف تكون اول مشكلاتك معه هي الترجمة، فقد تكون ذا مستوى مقبول او جيد في الانجليزية لكن انجليزية الفلسفة تختلف، بسبب اصطلاحاتها ومدى تعقدها، اضف الى ذلك انك سوف تحتاج بالتاكيد، وكثيرا، ان تخرج من الكتاب للبحث خلف موضوعات بعينها.
في تلك النقطة قد يساعدك فيلسوف اخر يدعى د. جاريت ميريام وهو استاذ الفلسفة بجامعة انديانا، حيث يشرح جاريت كتاب جودفري-سميث على يوتيوب في 37 حلقة كل منها حوالي 25 دقيقة، وبذلك فان لدينا منهج فلسفة علم متكامل هنا، كتاب ومحاضرات تشرحه، وجاريت يشرح فلسفة العلم باسلوب ممتع وسلس للغاية، وقد اجتزت كامل شروحاته من قبل، وتعلمت الكثير منه، وكان بشكل رئيس موجّهي الخاص في تعلم هذا النطاق المعرفي الممتع “فلسفة العلم”، واظن ان هذا هو افضل مساق فلسفة علم ممكن.
العلم الزائف وادعاء الخوارق
هذا، ربما، ليس كتابا في فلسفة العلم بالمعنى المفهوم، لكن مقدمه، جوناثان سي سميث، وهو استاذ علم النفس بجامعة ميتشيجن، تقصّى على مدى نصف قرن ما نسميه “العلم الزائف”، وهو ادعاء نطاق ما انه علمي لكنه في الحقيقة يشبه العلم فقط، الميزة الرئيسة للكتاب هي ان سميث تخصص عبر رسالة الدكتوراه الخاصة به في تلك النطاقات المتعلقة بالعلاجات بالتامل، او الطاقة، الطب التكميلي، الطب البديل، والباراسايكولوجي.. الخ.
وما يفيد حقا، بجانب كون سميث من اوائل الذين قدموا نماذج مهنية لدراسة تلك العلوم الزائفة، هو اننا سوف نتعرف بشكل عملي على الطريقة العلمية عبر مقارنتها باليات اخرى غير علمية، بذلك فنحن في كتاب سميث لا ندرس تاريخ العلم او مدارس فلسفته، ولكن بالاحرى نطبق ما تعلمناه بطريقة معاصرة، كذلك يقدم سميث الية عمل جيدة يمكن ان تستخدمها بشكل شخصي لتفنيد كل الادعاءات التي تقابلك وذات علاقة بالعلم.
لهذا السبب فان العنوان الجانبي للكتاب هو “ادوات المفكر النقدي”، حيث عبر عدد ضخم للغاية، في حوالي 650 صفحة، من الامثلة يعطيك سميث دليلا عمليا للتفكير النقدي، وكيفية فصل ما يُعد علما عما لا يُعد كذلك، وبذلك فهو، رغم كونه لا يشرح “فلسفة”، يعد مقدمة جيدة للغاية ان كنت لا تود الدخول الى اجواء فلسفية، يمكن فقط ان تتعلم ادوات سميث واسئلته كـ “اين المصادر؟”، “هل تستند الادعاءات الى الملاحظة؟” و”ما البديل الممكن كـ تفسير؟”.. الخ.
اسلوب سميث سهل للغاية، يتعمد التبسيط، ويستخدم لغة يومية غير معقدة يمكن ان تقراها في الصحيفة مثلا، كذلك يستخدم عددا كبيرا من الاشكال التوضيحية والمقارنات، ويستخدم دائما فكرة الخطوات (1، 2، 3،… الخ) المبنية كل منها على سابقتها لتحقيق بنية منطقية سليمة، والاهم من ذلك انه يقسّم كتابه بشكل جيد يجذبك للاستمرار فيه، ورغم ضخامة الكتاب فان سهولته ستساعدك على اتمامه باسرع وقت ممكن مقارنة بسابقيه.
جميل جدا، اتممنا كتبنا الخمسة مع عدة مقترحات جانبية، ويمكن لتلك الكتب ان تمثل، معا، منهجا متكاملا لفهم ما تعنيه فلسفة العلم في العموم، لكن دعنا هنا تحت هذا العنوان نتامل عدة ملاحظات مهمة، فـ -مثلا- فلسفة العلم هي فرع من الفلسفة، مما يعني ان هناك احتياجا الى تعلم الفلسفة في البداية قبل الولوج الى فلسفة العلم، لكن لا تقلق، فما تحتاجه ليس بالكثير، كما ان البداية المباشرة مع فلسفة العلم سوف تدفعك بشكل مستمر الى الخروج من الكتب والبحث في اصطلاحات وموضوعات فلسفية ضرورية، وبوصولك الى بوبر مثلا ستكون قد كوّنت خلفية جيدة.
لكن ما اود الاشارة اليه هنا ان الرحلة مع فلسفة العلم لن تكون سهلة بالمرة، وشيئا فشيئا يجب ان تعود نفسك على نمط مختلف في القراءة لا يمكن ابدا ان تصلح معه انظمة “50 ورقة في الساعة”، بل في بعض الاحيان ولا 10 حتّى، القراءة في الفلسفة تتطلب بعضا من الصبر، والتاني، والاصرار على الاستمرار، وتتطلب ان تجعل من كتابك مركزا للانطلاق خارجا، حيث الكتب الاخرى، المقالات الفلسفية الطويلة من موسوعة ستانفورد الفلسفية مثلا او غيرها، او المحاضرات.
اضف الى ذلك ان هناك نطاقين اساسيين يجب على كل قارئ في فلسفة العلم ان يتعلم عنهما، اولهما هو العلم ذاته، بمعنى انه يجب ان تتعرف بشكل مباشر على العلم، وليس منهجيته، ويتطلب ذلك ان تدرس بعضا من الفيزياء مثلا كونها تعد الاساس لفلسفة العلم في القرن العشرين، واقصد تحديدا بعض الميكانيكا الكلاسيكية بمستوى طلبة السنة الاولى الجامعية، وكذلك ميكانيكا الكم والنسبية بمستويات مبسطة.
النطاق الثاني هو تاريخ العلم، فمن دون التعرف اليه يصعب عليك تحقيق تقدم ملموس، وهناك في الحقيقة عدة كتب يمكن ان تخدم هذا الغرض، اخترت لك منها كتابي “تاريخ العلم – جون جريبن” في جزئين، وقد صدر مترجما قبل عدة اعوام من قبل سلسلة عالم المعرفة التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالكويت، وكتاب “قصة العلم – ج. ج. كراوثر” والذي يشرح تاريخ العلم بشكل مختصر في حوالي 25 فصلا، وكلاهما ممكن القراءة لاي شخص دون مقدمات مسبقة، كذلك يمكن لكتاب مختصر بعنوان “الثورة العلمية – لورنس م. برينسيبيه” من سلسلة مقدمات قصيرة جدا، يشرح التحولات الرئيسة في المنهجية العلمية بالقرن السابع عشر مرورا بديكارت وجاليليو ونيوتن وكيف اختلفت رؤية الانسان للكون، الكتاب مترجم للعربية ومعروض مجانا بمؤسسة هنداوي.
اضف الى ذلك انه يمكن لك ان تعتمد، ان اردت، كمقدمة او كدعم، على تقارير ومقالات سابقة للكاتب، كاتب هذا التقرير، قدم من خلالها الموضوعات الاساسية لفلسفة العلم في صورة شاملة ومبسطة ومقدمة للقارئ العربي المبتدئ، تجدها بسهولة بالدخول الى صفحة الكاتب (بالضغط على اسمه بالاعلى)، وتشمل: القابلية للتكذيب، فلسفة العلم عند توماس كون، ما هي الفلسفة الوضعية المنطقية؟، ضد المنهج: فلسفة العلم عند باول فييرابند، هل يصف العلم الواقع؟، هل يمكن فصل العلم عن الفلسفة؟، لماذا تحتاج البيولوجيا الى فلسفة؟، وعبر موقع “اضاءات” قبل عمله بـ “ميدان”: هل العلم عقلاني؟، فلسفة العلم عند لاري لودان (جزءان)، مطاردة العقلانية: فلسفة العلم عند امري لاكاتوش.
حسنا، كانت رحلتنا الطويلة للحديث عن فلسفة العلم ذات زخم اكبر بالتاكيد من رحلاتنا السابقة في الكتب، اود فقط ان اضيف ان تلك كانت خطة كاتبها، ربما قد تجد قوائم اخرى ترشح مقدمات جيدة في فلسفة العلم غير هذه، لا مشكلة من ذلك لكن يجب ان تتاكد دائما من ان مقدم الكتاب لك قد تعرف الى هذه الكتب ولو بشكل جزئي، والى فلسفة العلم ولو قليلا، في النهاية لا تمثل الترشيحات -في العموم- الا دفعة واحدة الى الامام، وكزة، وبقية الطريق الطويل هو مهمتك الخاصة.خمسة كتب تقدم لك فلسفة العلم